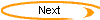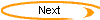
قراءة في كتاب: إغلاق عقل المسلم
لم يكن اهتمام الغرب بالإسلام جديداً، إذ سمعنا كثيراً عن المستشرقين ومؤلفاتهم في هذا الخصوص، إلا إن ذلك كان محصوراً في نخبة ضيقة من الاختصاصيين
والأكاديميين. ولكن في أعقاب جريمة 11 سبتمبر 2001، حصل اهتمام واسع النطاق في الغرب للتعرف على الإسلام كدين وفهمه، ليس من قبل الانتلجنسيا فحسب، بل وحتى من قبل العوام،
وذلك لمعرفة الأسباب التي دفعت 19 شاباً عربياً مسلماً، من حملة شهادات عالية من جامعات غربية، ومن عائلات ميسورة، إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، يضحون بأنفسهم ويقتلون
نحو ثلاثة آلاف من الأبرياء. فالإنسان السليم لا يستطيع فهم هذه الظاهرة بسهولة، ناهيك عن الإنسان الغربي الذي يعتبر حياة الإنسان قيمة مطلقة.
لذلك خصصتْ الحكومات الغربية، وجامعاتها ومراكز البحوث فيها، قسطاً وافراً من طاقات منتسبيها وأموالها لدراسة هذه الظاهرة، لغايات عديدة منها:
-
أولاً، لحماية شعوبهم والحضارة البشرية من شرور الإرهاب الذي يرتكب باسم الله والإسلام،
-
ثانياً، لمعرفة الإسلام نفسه كدين، ولماذا وصل به الأمر إلى هذه الأزمة... وأين يكمن الخطأ؟
-
ثالثاً، لماذا يدعو الإسلام المسلمين إلى احتقار الحياة وتمجيد الموت، والتضحية بالنفس وقتل الآخر لمجرد أنه يختلف عنهم في الدين
والمذهب؟
ولفهم هذه الظاهرة، صدرت مئات الكتب والبحوث، وآلاف الدراسات والمقالات، ومنها كتاب قيم نحن بصدده في هذه القراءة، صدر في عام 2011، بعنوان: (إغلاق عقل
المسلم) وعنوان ثانوي: (كيف خلق الانتحار الثقافي أزمة الإسلام الحديثة)، للباحث والأكاديمي الأمريكي، الدكتور روبرت رايلي (Robert R. Reilly).
من حسن الصدف أني التقيت بالمؤلف في مؤتمر روما لإصلاح الإسلام في نهاية العام الماضي، ومن خلال محادثاتي معه، و قراءتي لكتابه فيما بعد، عرفته ذا إطلاع واسع في تاريخ
الإسلام، مع فهم عميق للعقل العربي والإسلامي بصورة خاصة. لذلك، رأيت من المفيد تقديم عرض لهذا الكتاب القيم، لفائدة كل من له اهتمام بالمشكلة التي تعرض لها المسلمون
والعالم من الإرهاب.
يرى المؤلف أن سبب الإرهاب الإسلامي اليوم لم يكن جديداً، وليس لأسباب اجتماعية مثل الفقر...الخ، وإنما لخلل أصاب عقل المسلم كنتيجة لسلسلة من التطورات حصلت في الفكر
الإسلامي، بدأت في القرن التاسع الميلادي، وقد وصل إلى ما هو عليه اليوم كنتيجة حتمية لهذه العقلية. لذا فيتتبع المؤلف جذور المشكلة من خلال انعطافات تاريخية منذ بداية
ظهور الإسلام، مع التركيز على التطورات الفكرية في العصر العباسي.
يقول المؤلف في المقدمة، أنه يبحث في واحدة من أعظم الدراما في التاريخ البشري، مسرحها عقل المسلم، وكيف تعامل السلف من فقهاء الإسلام مع العقل، خاصة بعد تعرضه للفكر
اليوناني في عهد الخليفة العباسي، المأمون، العملية التي يسميها بـ
(Helenization of Islam)،
أي تلقيح الثقافة الإسلامية بالفلسفات اليونانية (الهيلينية) القديمة، وبالأخص فلسفة أرسطو، كما حصل للمسيحية في أوربا.
فيقارن المؤلف بين الحضارتين، الغربية والإسلامية، ويؤكد الفكرة السائدة أن الحضارة الغربية نشأت من أربعة مصادر:
-
الديانة المسيحية،
-
والديانة اليهودية،
-
والفلسفة اليونانية
-
والقانون الروماني.
هذه الحضارة ازدهرت ثم تفسخت في القرون الوسطى، لتنهض من جديد في عصر النهضة والأنوار إلى أن بلغت هذا المستوى المتفوق اليوم من التقدم العلمي والتقني
والفني والفلسفي، وحقوق الإنسان، والحرية والديمقراطية...الخ. ويرى أن ما كان لهذا التقدم أن يحصل لولا اهتمام فلاسفة الغرب بالعقل والعقلانية.
أما الإسلام الذي بدأ في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية، ورغم أنه حقق نهضة سريعة، فخلال ثلاثة قرون انتشرت الحضارة الإسلامية في شمال افريقيا، والشرق الأوسط،
ومناطق نائية في وسط وشرقي آسيا، وحتى غربي أوربا، وأسست المدن والمعاهد العلمية والمكتبات، ثم انهارت هذه الحضارة في القرن الثاني عشر الميلادي وغاص العالم الإسلامي في
ظلام دامس، ولم تنهض كما نهضت الحضارة الأوربية.
لذا يسأل المؤلف: لماذا لم تحصل النهضة في العالم الإسلامي بعد كبوته على غرار ما حصل للغرب؟
يركز المؤلف على ما حصل للفكر الإسلامي من تطور في العهد العباسي، وبالأخص في فترة الخليفة المأمون، حيث صعدت حركة المعتزلة الفكرية العقلانية، وهي امتداد لحركة القدرية
(من القدرة والإرادة الحرة في أخذ القرار). فالمعتزلة هم دعاة منح الأولوية للعقل على النقل، وفلسفتهم تتركز على أن الإنسان مخيَّر ويتمتع بالإرادة الحرة، لأنه يمتلك
العقل الذي بواسطته يستطيع التمييز بين الخير والشر، والعدالة والظلم، لذالك فهو مسؤول عن نتائج أعماله وفق الآية: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر
يرى)، وبدون هذه الإرادة الحرة في الاختيار، فالإنسان غير مسؤول عن أعماله، ولذلك ليس من العدالة معاقبته إذا ارتكب جرماً. وهذه المدرسة هي على خلاف المدرسة الفكرية
الأخرى التي تسمى بـ(الجبرية) التي تقول أن الإنسان مسيَّر، ولا إرادة له في أخذ قراراته وصنع أعماله، لأن كل ما يعمله ويتعرض له هو مكتوب عليه من الله منذ الأزل وقبل
ولادته. والجدير بالذكر، أن خلفاء بني أمية شجعوا هذه المدرسة الفكرية لتبرير ظلمهم، بأنهم إذا كانوا ظالمين فإن الله هو الذي سلطهم على رقاب المسلمين، فالظلم ليس ذنبهم،
بل بإرادة الله!.
والخليفة عبدالله المأمون نفسه كان معتزلياً عقلانياً، محباً للفلسفة ومن أنصار العقل، حيث ازدهرت الثقافة والحركة الفكرية في عصره، فأسس بيت الحكمة في بغداد، وشجع ترجمة
الكتب من مختلف الثقافات، الهندية، والفارسية واليونانية.
ويقال أن سبب تحول المأمون إلى المعتزلة والعقل ضد النقل، أنه رأى أرسطو في المنام، فنصحه بأن العقل هو أهم مصدر لمعرفة الحقيقة، فالفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل.
لذا أيد المعتزلة ودعم حركتهم، وأسند لهم المناصب وخاصة في القضاء. والمعتزلة روجوا لفرضية (خلق القرآن) التي آمن بها المأمون بقوة، حيث فرضها كعقيدة رسمية للدولة، إلى حد
أن راح المعتزلة يمتحنون الناس، وكل من لا يقر بهذه الفرضية كان يتعرض للعقاب. لذلك سمي ذلك العهد بعهد المحنة، (من الامتحان). ومفاد هذه النظرية أن الله خلق القرآن
وأنزله على محمد بلسان عربي مبين. ولكن يرى خصومهم أن القرآن كان موجوداً منذ الأزل مع وجود الله. ويستند المعتزلة في دعم رأيهم إلى الآية: (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم
تعقلون)، ويفسرون كلمة (جعل) بأنها تعني (خلق)، ولا فرق بينهما في المعنى. وقد يبدو هذا الجدال سفسطائياً، إلا إنه أثار فتنة واسعة في وقته. والجدير بالذكر أن الشيعة
يعتقدون بخلق القرآن، فالمعتزلة ليسوا من مذهب واحد، بل يوجد بينهم من السنة والشيعة.
ومن أبرز الذين عارضوا فرضية خلق القرآن، هو الإمام أحمد بن حنبل، مؤسس المذهب الحنبلي، فتعرض من جراء ذلك إلى السجن
والتعذيب، وصمد بشجاعة، مما كسب إعجاب الناس، ونال شعبية واسعة بين أهل بغداد. وتميز الحنابلة (أتباع مذهب ابن حنبل) عن غيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، بميلهم
إلى استخدام العنف ضد من يختلف معهم. وفي عصرنا الحاضر، الوهابية هي امتداد للمذهب الحنبلي، لذلك لا غرابة في تبنيهم للعنف بما فيه الإرهاب.
اعتمد المعتزلة على العقل في تفسير النصوص الدينية (الكتاب والسنة- أي الأحاديث النبوية)، بدلاً من الاعتماد على ما نقل إليهم من السلف.
ومن هنا بدأ الصراع بين المعتزلة (العقلانيين)، وأهل السنة الذين يعتمدون على ما نقل إليهم من السلف في التفسير الحرفي للنصوص الدينية بغض النظر عن تعارض المنقول مع
العقل، ويأخذون بكل ما نقل إليهم من أحاديث نسبت إلى النبي محمد، وأغلبها في رأي بعض الفقهاء مشكوك بصحتها، وبالأخص الإمام أبو حنفية (مؤسس المذهب الحنفي) الذي لم يأخذ من
الأحاديث النبوية سوى 17 حديثاً فقط، ورفض الباقي. وكان المعتزلة يسمون أنفسهم بأهل (العدل والتوحيد)، كما أطلق اسم (أهل السنة) على المحدثين، أي الذين يعتمدون على ما نقل
إليهم من الأحاديث النبوية.
تصاعد الصراع، وأخذ منحىً جديداً بين المعتزلة وأهل الحديث (السنة) عندما انشق أحد المعتزلة، أبو الحسن الأشعري (260هـ- 324هـ) في القرن التاسع الميلادي،
وهو المنظِّر الأول لمواقف أهل السنة، ومؤسس المذهب المعروف باسمه (الأشعرية)، بعد أن انشق عن المعتزلة إثر خلاف بينه وبين شيخه، أبو الهٌذَيل العلاف. وكما اعتنق المأمون
العقلانية بعد أن رأى أرسطو في المنام، كذلك الأشعري غيَّر موقفه من المعتزلة بعد أن رأى النبي في المنام ثلاث مرات، معاتباً إياه في المرتين الأولى والثانية على تخليه عن
أحاديثه، وأمره بالدفاع عن سنته، ولما عمل الأشعري بما أمره النبي، جاءه في المرة الثالثة وطالبه بالدفاع عن أحاديثه مع الالتزام بالعقلانية. لذلك أقام الأشعري مذهبا وسطا
جمع بين منهج المعتزلة في العقلانية والفكر السني المعتمد على الرواية والحديث مع معاداة المعتزلة كمذهب.
بلغ الصراع أشده في عهد المتوكل، حيث اضطهد المعتزلة وطاردهم، وقتل عدداً منهم، وفر من نجى، ليختفوا في المناطق النائية من الدولة العباسية، وذاب كثير منهم في المذهب
الشيعي. كما وأحرقوا مؤلفاتهم، ولم يبقَ منها سوى تلك النتف القليلة التي اقتبسها خصومهم لتفنيد آرائهم. وعلى سبيل المثال، كان الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر البصري
(159هـ-255هـ) معتزلياً، وقد ألف خلال عمره المديد نحو مائة كتاب، أكثرها في الفقه الإسلامي وفق منظور المعتزلة، إلا إنهم أحرقوا معظم كتبه ولم يتركوا منها إلا تلك الكتب
التي لم تتعرض للدين، مثل كتاب الحيوان، والبخلاء، والبيان والتبيين وغيره.
وكانت تلك الحملة ضد المعتزلة هي ردة في تاريخ الفكر العربي- الإسلامي، وبداية اغلاق عقل المسلم، والانحطاط الحضاري والفكري، وضعف الدولة
العباسية، وتمهيداً لسقوطها الأبدي بركلة من هولاكو عام 1258م. ولم يتعافى العقل العربي من هذا الانحطاط لحد الآن، وما بن لادن ومنظمته الإرهابية (القاعدة) إلا ثمرة سامة
من ثمار هذا الانحطاط الذي بدأ قبل 11 قرناً على يد الأشعري فكرياً، والمتوكل سياسياً.
وفي القرن الثاني عشر جاء الإمام أبو حامد الغزالي (1058م-1111م)، فشن حرباً شعواء على الفلسفة والعقل والعقلانية، فألف كتاباً بعنوان: (تهافت الفلاسفة)
لهذا الغرض. والجدير بالذكر أن الغزالي نفسه كان فيلسوفاً، واسع الاطلاع على علوم زمانه، فقد قرأ كتب الفلسفة إلى جانب ثقافته الواسعة بالمعارف الإسلامية، إلى حد أن
يعتبره البعض أعظم مثقف في الإسلام، لذلك لقبوه بحجة الإسلام. ولكن حصلت له أزمة نفسية عندما بدأ يشك في الدين والوحي نتيجة لقراءته كتب الفلسفة والمنطق، ثم صار صوفياً
واعتزل العالم في دمشق. وكان يتمتع بمكانة متميزة بين رجال الدين وطلبة العلوم الإسلامية، لذلك كان لانقلابه على العقل تأثير مدمر على الفكر الإسلامي. ومنذ ذلك الوقت وضع
الغزالي الختم على عقل المسلم. فالعقل بالنسبة للغزالي هو العدو الأول للإسلام، لذا رأى أن على المسلم الإستسلام الكلي إلى إرادة الله، أي كل ما جاء في الوحي من قرآن وسنة
النبي، ومن السلف الصالح من تفسير للنصوص والشريعة بدون أي سؤال أو مناقشة.
تهجم الغزالي في كتابه (تهافت الفلاسفة) على افلاطون وأرسطو وأتباعهما، وقال أن الفلسفة لا تنقذ الإنسان من الظلام والتناقض وإنما الوحي وحده ينقذه.
ثم جاء ابن تيمية (1263م-1328م)، وهو أحد كبار فقهاء أهل السنة من المذهب الحنبلي المتشدد، فأطلق مقولته: (كل من تمنطق فقد تزندق).
وبعد أقل من قرن من وفاة الغزالي، ظهر ابن رشد ( 1126م - 1198م) في الأندلس، وكان فيلسوفاً متنوراً، ترجم بعض أعمال أرسطو إلى العربية، إضافة إلى مؤلفاته الغزيرة، حاول أن
يرد الاعتبار إلى الفلسفة والعقلانية، فرد على كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة) بكتاب (تهافت التهافت). إلا إن أغلبية المسلمين في ذلك الوقت كانوا قد اعتنقوا الأشعرية التي
جعلت الإيمان أكثر قبولاً بدون عقل. فوقفت السلطة الحاكمة ضد ابن رشد وسجنته وجمعت مؤلفاته (نحو 108 كتاباً) في ساحة المدينة (قرطبة) وأشعلت فيها النيران. وهكذا انتصر
الغزالي والأشعري على ابن رشد، وانتصر النقل على العقل.
وفي تلك الفترة (أوائل القرن الثاني عشر الميلادي) أغلق باب الاجتهاد لدى فقهاء الإسلام السني بدعوة من الغزالي، وقالوا أن السلف لم يتركوا
شيئاً إلا ووضعوا له تفسيراً وحلاً، وأن أي تفسير جديد للشريعة غير مقبول، فما كان صحيحاً في القرن الثاني عشر هو صحيح في كل زمان ومكان. يعني بلغة اليوم، أنهم وصلوا إلى
نهاية التاريخ، حسب تعبير فوكوياما! فالاجتهاد كان وسيلة تسمح للفقهاء إجراء بعض التعديلات حسب ما يتطلبه الوقت وما يفرزه من مستجدات، ولكن حتى هذا الهامش البسيط من
الحرية تم إلغاءه.
وفي القرن الثامن عشر الميلادي ظهر في نجد محمد ابن عبدالوهاب (1703م - 1791م) فأسس الحركة الوهابية، دعا فيها إلى العودة إلى أصول الإسلام في عهد الصحابة
والرسول، مبرراً استخدام العنف ضد المختلف. والجدير بالذكر أن الوهابية هي وراء الحركات الجهادية، ومنها منظمة (القاعدة) التي أسسها بن لادن في أواخر القرن العشرين،
ومازالت تنشر الإرهاب في العالم.
وفي عام 1928 برز في مصر الشيخ حسن البنا، وأسس حزب الأخوان المسلمين. وفي منتصف القرن العشرين، ظهر سيد قطب، وهو منظر الحركات الجهادية وصاحب كتاب (معالم في الطريق) الذي
أدان فيه الحضارة الغربية ودعا إلى الجهاد لقيام حكم إسلامي على غرار الخلافة الراشدية. طالب سيد قطب المسلمين أن ينفضوا عنهم تراكم العصور من التخلف، ويعودوا إلى عصر
الصحابة ويسيطروا على العالم من جديد ويعيدوا عصر الخلافة. وكغيره من الإسلاميين المولعين بنظرية المؤامرة، أوعز سيد قطب سقوط الخلافة العثمانية إلى تآمر اليهود في
اسطنبول. وكداعية للعنف الجهادي، نعت سيد قطب المسلمين غير المتدينين بالأعداء من الداخل الذين يجب التخلص منهم من أجل تحضير الجبهة الداخلية لمواجهة الغرب الكافر دون
التلوث بالأيديولوجية الغربية.
وأخيراً ظهر الشيخ محمد قطب، وهو شقيق سيد قطب، وأستاذ بن لادن، وصاحب كتاب (جاهلية القرن العشرين) الذي اعتبر كل ما أنتجه الغرب من معارف وثقافات وفلسفات
وعلوم وتكنولوجيا وحضارة وحداثة...الخ، منذ ما قبل سقراط وإلى الآن، هو جهل في جهل، وأن الثقافة الحقيقية هي الإيمان بالقرآن والسنة فقط.
يستدرك المؤلف أن هذا لا يعني أن عقل كل مسلم منغلق، أو لا توجد مذاهب أخرى في الإسلام فيها انفتاح، وإنما يعني القطاع الأكبر من الإسلام السني الذين أغلقوا العقل وسدوا
باب الاجتهاد، وحاربوا الفلسفة، ويستثني الشيعة لأنهم تركوا باب الاجتهاد مفتوحاً، وأشار إلى أن الإسلام الشيعي يحتاج إلى بحث مستقل.
وهنا أود توضيح مسألة لم يشر إليها المؤلف وهي، أن فقهاء الشيعة، رغم إبقائهم باب الاجتهاد مفتوحاً، إلا إنهم نادراً ما يستخدمونه بشكل فعال، أو يجرون أي تغيير يذكر وذلك
خوفاً من العامة، لأن وارداتهم المالية تأتي من العوام، وليس من الحكومات كما في حالة رجال الدين السنة.
وبالعودة إلى السؤال الذي طرحه المؤلف: لماذا لم تحصل النهضة في العالم الإسلامي على غرار ما حصل في أوربا؟
يؤكد المؤلف على أن السبب هو تعطيل دور العقل في العالم الإسلامي. فالإنسان يتمتع بغريزة حب الاستطلاع، الفضول curiosity، وكسب المعرفة، واكتشاف أسرار الطبيعة، وإخضاع كل
شيء للسؤال، وتوسيع مداركه بالمعارف، ولولا هذا الفضول عند الإنسان لما حصل هذا التقدم الحضاري والعلمي، والاكتشافات والاختراعات، ولبقي الإنسان بدائياً همجياً إلى الأبد.
ولكن من الجانب الآخر، يرى الكاتب أن إعمال العقل في البحث والتنقيب والمناقشة والمحاجة، يؤدي بالتالي إلى زعزعة الإيمان الديني الموروث من الآباء.
وهنا يسأل المؤلف: هل من غرابة بعد كل هذا الجمود واغلاق العقل، أن تصدر فتاوى عجيبة وغريبة مثل فتوى إرضاع الكبير، وانتشار الإرهاب؟ كذلك أدمن المسلمون على نظرية
المؤامرة، إذ اعتادوا على إلقاء اللوم في تخلفهم على الغرب، بينما يرى أن اللوم يجب أن لا يقع على الغرب لنجاحه، بل على العالم الإسلامي لفشله. وهذا الفشل لم يكن نتيجة
للإسلام كدين، وإنما نتيجة حتمية للانتحار الثقافي والعقلي الذي حصل قبل 11 قرناً.
كما يشخص المؤلف أن هناك مسلمون يعرفون العلة والعلاج، ولكنهم بلا جمهور، ولا أنظمة سياسية حاكمة ترغب في الإصغاء إليهم أو تحميهم. فهناك معركة حامية داخل الإسلام نفسه.
وهذا الكتاب يعمل لفهم هذه المعركة ونتائجها. فيستشهد المؤلف بقول لباحث أكاديمي باكستاني وهو الأستاذ فضل الرحمن: "إن شعباً يحرم نفسه الفلسفة لا بد وأن يحرم نفسه من
الأفكار الحديثة، أو بالأحرى يرتكب انتحاراً ثقافياً".
يقول المؤلف، هناك سبيلان لإغلاق العقل، الأول، هو إنكار قدرة العقل على إدراك الواقع والحقيقة. والثاني، إنكار وجود الواقع الذي يمكن إدراكه. ويسأل: هل بإمكان العقل
إدراك الحقيقة؟ وهل بإمكان معرفة الله عقلياً؟ ومن هنا حصل شرخ كبير بين العقل والحقيقة، أي بين العقل وبين الله. هذا الإنفصام ليس في القرآن، بل في الثيولوجيا الإسلامية
المبكرة، والذي أدى إلى إغلاق عقل المسلم.
من الأشعري إلى بن لادن
ومن كل ما تقدم، يستنتج المؤلف، أن الإرهاب الإسلامي الذي نشهده اليوم هو نتاج إغلاق عقل المسلم الذي بدأ في القرن التاسع الميلادي على يد الأشعري. فالمشكلة فكرية كبيرة
لأنها تشمل حرمان المسلمين من التطور والنمو العلمي، ونشوء أنظمة ديمقراطية ذاتياً. إن إغلاق العقل هو السبب الرئيسي لتخلف العرب، وانحدارهم إلى أسفل سلم التنمية البشرية
وخاصة في العلوم، مستشهداُ بتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العالم العربي لعام 2002. ويرى أن هذا هو سبب عدم تصديق العرب لحد الآن بنزول الإنسان على سطح القمر
مثلاً، أو كروية الأرض ودورانها حول محورها كل 24 ساعة، وحول الشمس كل 365 يوماً وربع اليوم، ويعتقدون أن الكوارث الطبيعية مثل إعصار كاترينا، هو انتقام من الله على البشر
لمخالفتهم أوامره.
ويسأل الدكتور رايلي: هل الإرهاب الإسلامي هو نتاج الإسلام كدين، أم الإسلاموية، أي الإسلام السياسي؟ وهل الإسلاموية هي صورة مشوهة من الإسلام؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن
أين أتى هذا التشويه؟ ولماذا الإسلام دون غير من الأديان معرض إلى هذا النوع من التشويه؟ ويحاول الإجابة على هذه التساؤلات في القسم الأخير من الكتاب.
المشكلة الأخرى عند العرب هي تحفظهم وريبتهم من كل شيء غير عربي. فلما بدأ الانفتاح على الثقافة الهيلينية في عهد المأمون، ونظراً لعدم
معرفتهم بالعلوم، أطلقوا عليها تعبير: "العلوم الدخيلة". والمؤسف أنه لحد الآن يستخدمون هذا التعبير التسقيطي للحط من المعارف التي يتلقاه المسلم من بلدان غير مسلمة.
ونستنتج من كل ما تقدم، أنه لولا الأشعري وحربه على المعتزلة، والغزالي وحربه على الفلسفه والعقل، ولو استمر المعتزلة في نهج العقلانية، ولو انتصر ابن
الرشد على الغزالي، لما انغلق عقل المسلم، ولما تم تعطيل العقل وشل الفكر، ولما ابتلى المسلمون بنظرية المؤامرة، وإلقاء كل كوارثهم وتخلفهم وفشلهم على الأجانب والمؤامرات
الدولية... والصهيونية وغيرها، و لكان وضع المسلمين مختلف الآن. فعقل المسلم هو عقل اتكالي، لا يثق بنفسه، مما أدى إلى حالة الركود